الخطاب والسلطة: مراجعة شاملة
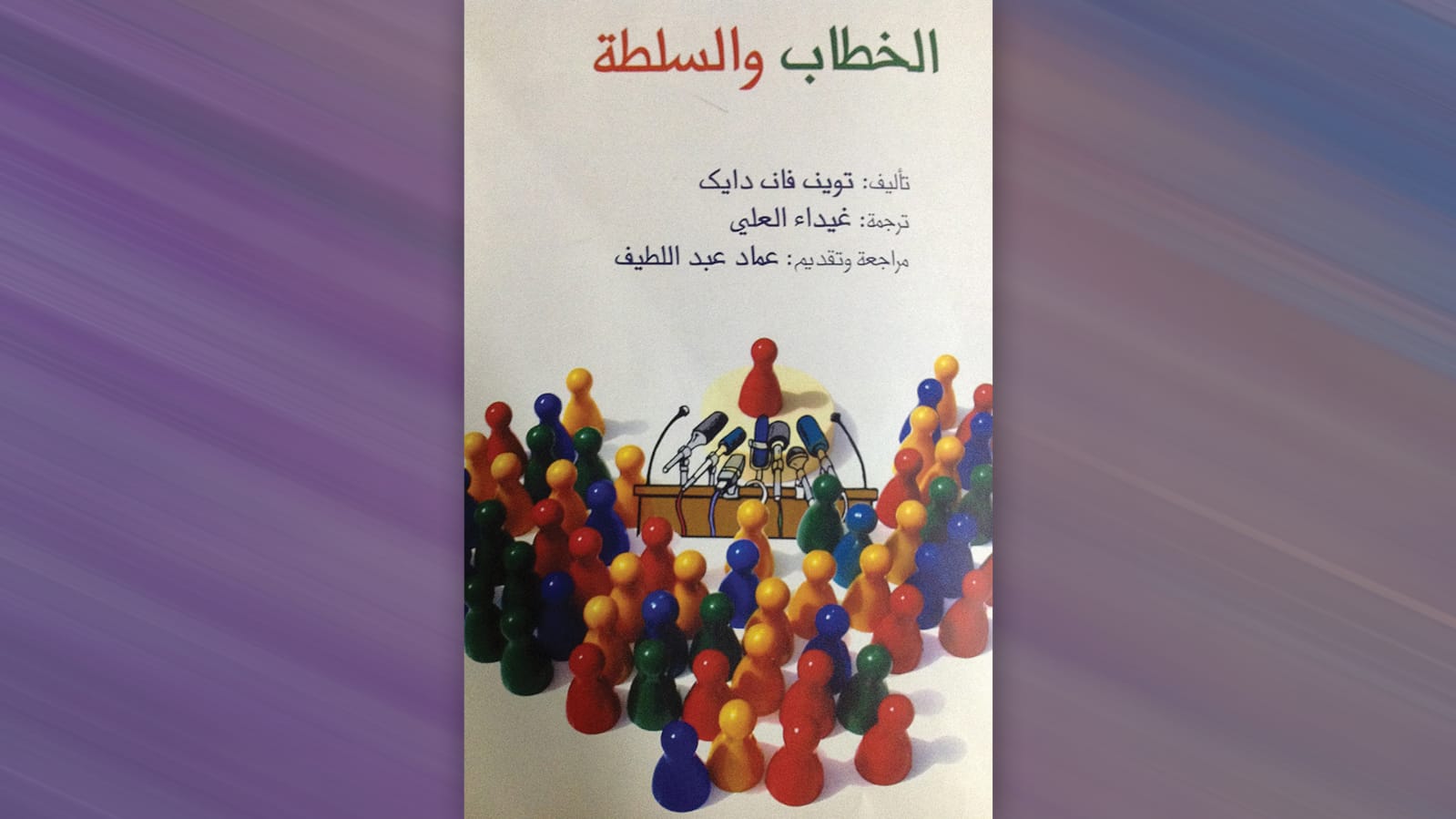
يمثل كتاب الخطاب والسلطة إسهامًا رائدًا في دراسة العلاقة بين اللغة والسلطة داخل المجتمعات المعاصرة. إذ يتجاوز الكتاب التحليل اللغوي التقليدي للخطاب، ليقدّم رؤية متكاملة تربط بين اللسانيات والنظرية الاجتماعية، مركّزًا على كيفية تشكّل السلطة وإعادة إنتاجها عبر الخطاب في المجتمع. من خلال هذا المنظور، يسلط الكتاب الضوء على الاستراتيجيات التي من خلالها تتحكم اللغة في تشكيل الوعي المجتمعي وإعادة إنتاج الهيمنة، ما يجعل من تحليل الخطاب النقدي أداة حيوية لفهم العلاقات المعقدة بين اللغة والمجتمع.
يعتمد المؤلف في كتابه على مقاربة جديدة، تهدف إلى كشف البنى الكامنة وراء الخطابات اليومية والسياسية، وفهم كيف تساهم هذه البنى في ترسيخ أو مقاومة السلطة، وذلك مرورًا بالبعد الإدراكي للفرد والمجتمع ككل. فالخطاب، كما يوضح الكتاب، ليس مجرد لغة تنقل معلومات، بل هو ممارسة اجتماعية بحد ذاته، وهو -أيضا- ميدان لمقاومة سوء استغلال السلطة التي يعاد إنتاجها في الخطاب. هذه المراجعة تقدم قراءة نقدية للكتاب، مع التركيز على استعراض الأفكار الرئيسة والمقاربة التحليلية التي يوفرها، كما تبحث في التحديات التي تواجهها أطروحة الكتاب في المجتمع المعاصر.
تكمن أهمية الكتاب في قدرته على تحويل القارئ من متلقٍ سلبي للخطابات -يساهم في إعادة إنتاج الأيديولوجيا المهيمنة- إلى محلّل واعٍ -ومقاوم- لها، قادر على كشف الأيديولوجيا التي تعمل خلف النصوص والكلمات. من خلال هذا التحليل، يمكن للباحثين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية تطوير فهم معمق لكيفية عمل الخطابات في تشكيل الممارسات الاجتماعية والسياسية، وبالتالي المساهمة في نقدها وفك رموزها، وذلك إيمانًا من المؤلف بأهمية التغييرات الجزئية (Micro Changes) بوصفها أساس التغييرات الكلية في المجتمع. هذه المراجعة تمثل محاولة لتقديم خلاصة واضحة لأهم مضامين الكتاب وأثره في تطوير أدوات التحليل النقدي للخطاب، وتشكل دعوة للغوص في دراسة العلاقة المعقدة بين اللغة والسلطة.
يقدّم فان دايك في كتابه الخطاب والسلطة، الذي نقلته إلى العربية غيداء العلي وصدر عن المركز القومي للترجمة، مقاربته الاجتماعية-الإدراكية لتحليل الخطاب. ويقع الكتاب في نحو 571 صفحة موزّعة على عشرة فصول/مقالات، بالإضافة إلى المراجع ومسرد المصطلحات. تتميز مقاربة فان دايك عن غيره من محللي الخطاب النقدي باشتمالها على عنصر وسيط بين المجتمع والخطاب، وهو الإدراك؛ إذ يحلل فان دايك العلاقات المتبادلة ضمن ما يسميه بـ”مثلث الخطاب”، أي الخطاب والإدراك والمجتمع، مع تركيز كبير على تحليل البنى الجزئية (كالنصوص والحديث والعمليات الإدراكية) لوقف الهيمنة والسيطرة التي تحدث على المستوى الكلّي (المجتمع). وبسبب هذه الخصائص، يتسم إطاره النظري بالمرونة والتغير تبعًا للمشكلة قيد الدراسة، ويفيد فان دايك كثيرًا من التخصصات المختلفة المتداخلة مع موضوعه والنتائج والمفاهيم التي تم التوصل لها مسبقًا ولا يدخل في مناقشات تفصيلية -كفيركلاف مثلا- في المفاهيم الكلّية، على الأقل بمقدار تركيزه على المفاهيم الإدراكية واللغوية العملية الجزئية. كما يدعّم فان دايك مناقشاته بالكثير من الأمثلة التطبيقية من مختلف ميادين الخطاب، وبخاصة الخطاب الإعلامي والسياسي.
ما هي دراسات/تحليل الخطاب النقدي (Critical Discourse Studies/Analysis)؟
يمكننا النظر إلى تحليل الخطاب النقدي بوصفه إحدى المحاولات المهمة في حقل اللسانيات للانتقال من البنى الجزئية للّغة (الكلمات والجمل بحد ذاتها) إلى البنى الكلية لها (الخطابات) والنظر في تداخلاتها مع المجتمع والنظرية الاجتماعية، وكذلك بوصفه جزءًا من التقليد المعادي للمقاربات والمناهج الليبرالية والنظامية و”غير النقدية” السائدة في العلوم الاجتماعية في السبعينيات والستينيات.
نشأ تحليل الخطاب النقدي (CDA) في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات على يد عدد من الأكاديميين منهم نورمان فيركلاف، وتوين فان دايك وروث ووداك وغيرهم، ويعد كتاب فيركلاف اللغة والسلطة بمثابة بداية ظهور تحليل الخطاب النقدي. نشأت دراسات الخطاب النقدية بدايةً بوصفها تحليل الخطاب النقدي، أي (Critical Discourse Analysis) عوضًا عن دراسات الخطاب النقدية (Critical Discourse Studies)، إلا أن عددًا من المفكرين، ومن ضمنهم مؤلف كتابنا فان دايك، بدأوا يفضلون إطلاق اللفظ الأخير على هذا الحقل عوضًا عن اللفظ الأول؛ وذلك بسبب التنوع الكبير والمتزايد في المناهج والتخصصات والمفاهيم المستخدمة تحليل الخطاب، وهو الأمر الذي يراه البعض إيجابيًا؛ إذ يحتاج الربط بين الخطاب والمؤسسات والممارسات غير الخطابية إلى جهد وتعاون كبيرين من مختلف التخصصات للتوصل إلى نتائج تفي بمعايير جميع التخصصات، كالتحليل الإثني وتحليل المحادثة والاجتماع وحتى التحليل المعماري وغير ذلك، ويراه بعض النقّاد أمرًا سلبيًا؛ إذ أدى ذلك إلى حالة من عدم الوضوح المنهجي والمفاهيمي مع إعادة تعريف المفاهيم الأساسية والأطر العامة من قبل كل محلل، وهو ما أدى بنظر فاولر إلى اعتبار “أي شيء بمثابة تحليل نقدي للخطاب”1.
يدرس التحليل النقدي للخطاب حالات حقيقية، وغالبًا ما تكون ممتدة، للتفاعل الاجتماعي الذي يتخذ -جزئيًا- شكلًا لغويًا. وفي هذا السياق، يجب أن نفرق بين دراسات الخطاب النقدية ودراسات الخطاب العادية أو غير النقدية (Discourse Studies)؛ إذ حدد دارسو الخطاب النقدي لأنفسهم هدفًا يفوق تحليل الخطاب العادي من البداية، وهو كشف أشكال الهيمنة واللامساواة الاجتماعية التي يتم إعادة إنتاجها وشرعنتها والتعبير عنها في/عبر الخطاب، والدعوة إلى التدخل والتغيير المباشر للبنى الجزئية للخطاب لإزالة هذه الأشكال من الهيمنة واللامساواة؛ أي أن دارس الخطاب النقدي يمتلك موقفًا ورسالة اجتماعية لا يؤمن بالعلم الخالي من القيم (Value-Free) ويضع مجموعة من المواقف والأهداف الاجتماعية صوب عينيه في أثناء بحثه؛ إذ يقوم دارس الخطاب النقدي بإبداء توجهاته بشكل صريح فيما يكتب، مع الحفاظ -في الوقت نفسه- على قدر من الموضوعية العلمية الضرورية للبحث العلمي، حيث هدف تحليل الخطاب النقدي منذ البداية إلى ربط الخطاب واللغة بالنظرية الاجتماعية، وبخاصة المدارس والمفكرين المرتبطين باليسار السياسي، كغرامشي وفوكو وألتوسير وهابرماس والماركسية والماركسية الجديدة والمدرسة النقدية والبنيوية وما بعد البنيوية؛ فالخطاب، قبل كل شي، هو ظاهرة اجتماعية لا يمكن دراستها لغويًا دون أساس اجتماعي متماسك، وكما عبّر فيركلاف:
“من السمات المهمة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أواخر الحداثة أنها توجد كخطابات وكذلك كعمليات تجري خارج الخطاب، وأن العمليات التي تجري خارج الخطاب تتشكل بشكل جوهري من خلال هذه الخطابات.”2
وينظر إلى دراسات الخطاب النقدية بوصفها متوازنة من حيث تأثير المدارس المختلفة الواقع عليها؛ فلا توغل في مدرسة فكرية معينة دون الأخرى؛ فترفض -مثلًا- النسبية المطلقة لما بعد البنيوية وأولوية الخطاب على كافة أشكال التفاعل الاجتماعي الأخرى؛ فالتفاعل الاجتماعي هو -كما ذكر فيركلاف- مشكّل جزئيًا عبر الخطاب، ولا تنفي بذلك وجود المطلق أو الحقيقة ولا تنكر أهمية الواقع المادي في تشكيل التفاعل الاجتماعي، وهو ما يتبين -مثلا- في التراث الماركسي التقليدي الماثل في معظم مقاربات تحليل الخطاب النقدي، وهو ما سنأتي على ذكره لاحقًا.3
بينما يقوم تحليل الخطاب العادي بدراسة بنية الخطاب لغويًا وكيف يقوم الخطاب بإضفاء المعنى على الأشياء، دون إضفاء أي بعد سياسي واجتماعي على الخطاب، ودون تداخل بين التخصصات لدراسة الخطاب بوصفه ظاهرة اجتماعية أكثر تعقيدًا، والأهم من ذلك، دون هدف اجتماعي محدد من تحليل الخطاب. وبعبارة أخرى، إن دراسات الخطاب النقدية، وعلى عكس دراسات الخطاب العادية، ليست مهتمة باللغة بحد ذاتها، بل بالظاهرة الاجتماعية بشكل أعم، وهو ما يتطلب تعددًا منهجيًا وتخصصيًا لدراستها ومقاومة مظاهر الهيمنة الحاصلة اجتماعيًا. بالإضافة إلى ذلك، يميز فيركلاف بين دراسات الخطاب النقدية ودراسات الخطاب غير النقدية، محددًا الخط الفاصل بينهما في “التوجه الاجتماعي للخطاب”4، مؤكدًا -في الوقت ذاته- على النتاجات العلمية التي أتت بها المنهجيات أو المدارس غير النقدية، وهي التي استفاد منها فيركلاف في صياغة منهجيته الجديدة في تحليل الخطاب (CDA). ومن الضروري التنبيه في هذا السياق على أن البعد النقدي -وهو الفرق الأساسي بين تحليل الخطاب النقدي وغيره- في دراسات الخطاب لا يعني بالضرورة أمرا سلبيًا، بل يؤكد على البعد الأساسي لهذه الدراسات، والمتمثل بمشكلة (problematize) موضوع البحث بإخراج البديهيات والمسلّمات من هذه الدائرة إلى دائرة التشكيك؛ للوصول إلى فهم أكثر وضوحًا حول الظاهرة موضع الدراسة، وهو -أي هذا الفهم- الذي سيبقى موضع شك بدوره في المستقبل، كما تشير كلمة “نقدي” كما عبّر هوركهايمر، إلى الرغبة في الانتقال بالنظرية الاجتماعية من نطاق التفسير والفهم إلى تغيير المجتمع بالكلّية، وهو الفهم الذي تبنته دراسات الخطاب النقدية إلى حد كبير. 5
وكان هنالك ضمن السياق العام الذي جاءت فيه هذه المقاربة الناشئة عدة محاولات لربط اللغة بالنظرية الاجتماعية، ويذكر فيركلاف في كتابه الخطاب والتغيير الاجتماعي أبرز هذه المـحاولات، والتـي لم تـخلق -برأيه- توازنًا بين النظرية الاجتماعية ودراسات اللغة؛ فمحاولات اللغويين النقديين في بريطانيا في السبعينيات، كروجر فاولر ومايكل هاليداي، أوجدت تحليلًا لغويا كفؤًا، ولكنها لم تكن على نفس المستوى فيما يخص التحليل الاجتماعي، ومحاولات ميشيل بيشو في فرنسا كانت على العكس من ذلك.
الأسس النظرية والمنهجية
ينظر فان دايك إلى دراسات الخطاب النقدية بوصفها حركة اجتماعية، ولا ينظر حتى إلى مقارباتها بوصفها مناهج، بل “طرق” لتحليل الخطاب، وكما وضحت سابقًا؛ فإن المقاربات في دراسات الخطاب النقدية قد تركز على مسائل فرعية ومجالات وحقول معرفية متباينة جدًا؛ فمقاربة ياغر على سبيل المثال تفيد بشكل ما من التحليل المعماري6، وتفيد عدد من الطرق الأخرى من مناهج وحقول مختلفة كتحليل المحادثة والإثنوغرافيا وغير ذلك. يرى فان دايك، إذن، أن دراسات الخطاب النقدية يجمعها إطار عريض يتمثل في البحث لوقف الهيمنة والظواهر الاجتماعية المرتبطة بها من تمييز جنسي وعرقي وما إلى ذلك، بالإضافة إلى العملية البحثية الرامية إلى إيجاد حلول واضحة وتطبيقية لتغيير الممارسات الخطابية المرتبطة بالهيمنة، وبعبارة أخرى، فإن ما يميز محلل الخطاب النقدي عن محللي الخطاب الآخرين هو دوره الاجتماعي والتزامه السياسي والوقوف في صف المهيمَن عليهم بشكل أساسي، وما ينبثق عن ذلك من تركيز على مسائل أكثر تحديدًا من مجمل الخطابات. ويعتبر فان دايك التحليل السيء هو ذاك الذي لا يسهم في التغيير الاجتماعي؛ ما يوضح مدى التوجه العملي والتطبيقي للتحليل النقدي للخطاب.
ويتسم الإطار النظري لمقاربة فان دايك بالمرونة العملية والتخصصية والتركيز على البنى الجزئية للخطاب (النصوص والمحادثات) والإدراك والمجتمع؛ إذ يتغير الإطار النظري تبعًا لموضوع الدراسة وقد يتم إضافة مفاهيم وأسس جديدة للإطار بحسب الموضوع. كما يفيد فان دايك في بناء إطاره النظري إلى حد كبير من الدراسات العملية التي أجريت سابقًا دون مناقشة تفصيلية للبنى والمفاهيم الاجتماعية الكلية، على الأقل بالمقارنة مع حجم المناقشة المعطى للبنى والاستراتيجيات الخطابية والإدراكية الجزئية، وهو ما يجعل القارئ يشعر، عند مناقشة بعض الأمثلة العملية، بعدم وجود ارتباط حقيقي بين البنى الجزئية والبنى الكلية، وهو هدف فان دايك الأساسي من تحليل البنى الجزئية؛ أي ربطها بالبنى الكلية للمجتمع. وكل هذا عائد إلى الطموح العملي الذي ذكرناه لمقاربات تحليل الخطاب النقدي والمرتبط بتغيير الممارسات اليومية والمعتادة التي تعبّر عن الهيمنة. ويتجلى ذلك أيضا في تجاوزه لنقاش نسبية المعايير واختلاف الثقافات بالتأكيد على أن عمله مبنيّ على “مقاييس العدالة والإنصاف الاجتماعي في عصرنا هذا أو بحسب حقوق الإنسان الدولية” دون مناقشة أطول لهذه المفاهيم التجريدية.
السلطة والأيديولوجيا
يفيد فان دايك من عدد من المفاهيم الاجتماعية التأسيسية التي يعتمدها لإطاره النظري من نتائج الدراسات السابقة المستمدة من المدرسة النقدية والماركسية الجديدة واليسار الجديد في بريطانيا، ويبنى مفهوم السلطة الحديثة ضمن هذا الإطار على فكرة السيطرة الرمزية غير المباشرة عوضًا عن المادية المباشرة؛ إذ تقوم المجموعات المهيمنة بالسيطرة إدراكيًا على رغبات وأحلام ومشاعر -وبالتالي أفعال- المجموعات الخاضعة عبر الخطاب وتنظيم الخطاب. وتؤكد هذه النظرة غير المباشرة للسلطة على العلاقة بين المجموعات بوصفها شرطًا أساسيًا لاستمرار السلطة نفسها، وهو ما يفتح المجال لمقاومة المجموعات الخاضعة. كما لا يلغي هذا المفهوم للسلطة والسيطرة الرمزية أهمية السلطة المادية المتمثلة بالجانب الاقتصادي والسياسي؛ فهي التي تتيح النفاذ إلى الخطاب في المقام الأول، بينما تبقى المجموعات الخاضعة في دور متلقي الخطاب أو من يُطلب منه الحديث (في المحاكم ومراكز الشرطة والمؤسسات البيروقراطية والإعلام).
ينتقل فان دايك لمناقشة مفهوم الأيديولوجيا مفيدًا في ذلك من عدة مقاربات من منظرّين في مجالات الدراسات الثقافية والأنثروبولوجيا وفلسفة العلوم والماركسية الجديدة. تشكّل الأيديولوجيا، بوصفها “وعي” مجموعة معينة أو إطارها الإدراكي، أساس ممارسات هذه المجموعة. وعندما تكون هذه المجموعة مهيمنة، تقوم بتطبيع ونشر هذه الأيديولوجيا في المجتمع ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية بوصفها معيارًا رسميًا ومحددًا لاختيار موضوعات الخطاب وبناء المناهج في التعليم والإعلام على سبيل المثال، أي تقوم باقي المجموعات باستبطان هذه الأيديولوجيا لتصبح جزءًا أساسيًا من -إن جاز لنا التعبير- “نظام الأشياء” لهذه المجموعات والشرط المسبق لكل أفعالها وخطاباتها. ويهدف فان دايك إلى كشف الأيديولوجيا المهيمنة في البنى الجزئية كالخطابات البرلمانية والخطاب الإعلامي لوقف عملية استبطان الأيديولوجيا المهيمنة في البنى الكلية للمجتمع.
ويبين فان دايك كيفية تتأقلم الأيديولوجيا مع ميادين الخطاب المختلفة (سياقات مختلفة) عبر تحليل الاستراتيجيات الخطابية المستخدمة في الحديث والنصوص، إذ عادةً ما تكون متشابهة في ميادين الخطاب المختلفة مع اختلاف في حدة الأفعال المستخدمة فقط، كالخطاب العنصري في المحادثات العامة والبرلمان؛ إذ يتبعان نفس الاستراتيجيات الخطابية وهي التي يكشف التحليل النقدي عنصريتها، ويعد الخطاب العنصري أحد أهم المجالات التي يصب فان دايك تركيزه التحليلي عليها، ويبين أن الخطاب العنصري قائم على استراتيجية شاملة ومركزية توجد في كل ميادين الخطاب، وهي المربع الأيديولوجي (أو استراتيجية الاستقطاب)، أي التفريق بينـ(نا) وبينـ(هم) وتمثيلنا إيجابًا والانتقاص من مساوئنا من جهة، وتمثيلـهم سلبًا والإبراز من مساوئهم من جهة أخرى، وتوجد عدد من الاستراتيجيات الخطابية الفرعية التي تساهم في تعزيز المربع الأيديولوجي وتشترك فيها مختلف مجالات الخطاب العنصري.
نماذج النفاذ/المدخل إلى الخطاب
تشير نماذج النفاذ/المدخل عند فان دايك -باختصار غير مخل- إلى دور المشاركين في الخطاب وطرائق مشاركتهم أو تصويرهم فيه، وتكمن أهميتها في أن أصحاب النفوذ (المادي) الأكبر يمارسون أكبر قدر من التأثير على النخب الرمزية (كالصحفيين والأكاديميين والخبراء وغيرهم)، وبالتالي يتحكمون -بشكل غير مباشر- بطرائق التنظيم الجزئي للخطاب (من الأمثلة على تنظيم الخطاب هو الخطاب في قاعات المحكمة، إذ يوجد فيها تنظيم سلطوي دقيق لكل تفاصيل الحديث والكتابة داخل المحكمة وظروفها) وهو ما يحكم عدة تفاصيل كنوع اللغة المستخدمة وتنظيم مجرى الحديث ونمط التواصل وغير ذلك، أي مضمون الخطاب نفسه، ولتوضيح أثر النفاذ إلى الخطاب، يقوم فان دايك بتوضيح ذلك عبر مفهومي السياق وبنى الخطاب، إذ تحدث السيطرة على العقل عبرهما، ويشير السياق إلى البنى العقلية لخصائص الموقف الاجتماعي المرتبط بإنتاج الخطاب أو فهمه، ويشمل أمورا مثل تعريف الموقف الكلي والزمان والمكان وميدان الخطاب والمشاركين في الخطاب فضلًا عن التمثيلات العقلية لهذه الأمور كالأهداف والأيديولوجيات، وهي أمور كثيرًا ما تتولى المجموعات المهيمنة تعريفها وتطبيعها، وهكذا يتبين كيف تتحكم المجموعات المهيمنة بكل من السياق وبنى الخطاب، أي تتحكم -بشكل غير مباشر وبعملية إدراكية معقدة- بالعقول. وهذا يرتبط بشكل مباشر بمدخل المجموعات المختلفة إلى الخطاب؛ إذ تبين عدد من الدراسات أن منفذ/مدخل الأقليات إلى الخطاب الإعلامي -مثلًا- عادةً ما يكون سلبيًا أو موجهًا نحو الأمور الأقل أهمية في المجتمع كالفنون والدين، وذلك بعكس المسؤولين وأعضاء المجموعات المهيمنة.
تكمن المشكلة الأبرز في مناقشة فان دايك لأمثلة عملية من ميادين الخطاب المختلفة فيما يتعلق بنماذج النفاذ/المدخل في تركيزه على الجزئيات الكمية المتغيرة -ويعود ذلك إلى الالتزام الاجتماعي لتحليل الخطاب النقدي والرغبة بالتغيير الآني والمباشر- كعدد العاملين من الأقليات في الإعلام، دون إعطاء آلية تفصيلية لكيفية استمرار هذه الأيديولوجيا العنصرية وإعادة إنتاجها في الخطاب على الرغم من زيادة عدد العاملين من الأقليات في ميادين الخطاب المختلفة، وكيفية استبطان الأقليات صاحبة النفاذ لهذه الأيديولوجيات ومساهمتهم تاليًا في إعادة إنتاجها، وإن كان ذلك بأشكال مختلفة، وهو الأمر الذي أشار إليه سابقًا ولكن دون تحليل حقيقي لآلياته. وبعبارة أخرى، لا يزودنا فان دايك بطريقة لتحليل آلية استيعاب الأقليات ضمن السلطة وأيديولوجيتها، كما أن فان دايك يركز في تحليله للخطاب الإعلامي على الصحف اليمينية والعنصرية بشكل واضح فقط، ولا يناقش بتفصيل كيف يساهم الخطاب الليبرالي و”المحايد” حول الأقليات في إعادة إنتاج الأيديولوجيا العنصرية، وإن كان ذلك بأشكال مختلفة عن الصحف اليمينية، كالتعامل مع الهجرة بوصفها مشكلة بشكل عام وتتطلب مساعدتنا وتفهمنا والاختلاف الثقافي عن الأقليات وغير ذلك، وهي الأمور التي يشير إليها فان دايك ولكن دون مناقشة وتحليل مستفيض.
أولوية الخطاب السياسي
يبين فان دايك أن الخطاب السياسي هو الذي يتولى في معظم الأحيان تعريف الخطوط العامة العريضة حول المسائل العرقية كالهجرة والجرائم، وذلك عبر المؤسسات والمسؤولين الرسميين، ثم يقوم الإعلام باعتماد هذه المصادر والرواية الرسمية في أخباره وتقاريره، وهو ما ينعكس على المحادثة العامة أخيرا؛ إذ يعمد الناس في معظم الأحيان على الاعتماد على المؤسسات الإعلامية الكبرى في معتقداتهم وآرائهم؛ إذ تؤكد تحليلات فان دايك العملية لآلاف التقارير الإخبارية وعدد من المقابلات الشخصية وجود حالة من التوازن بين موضوعات الحديث اليومي وموضوعات وسائل الإعلام. ونلحظ مما سبق أولوية الخطاب السياسي (خطاب النخبة) على بقية أنواع الخطاب وتأثيره فيها بشكل أكبر من العكس؛ ولذلك يحاول فان دايك -ودارسو الخطاب النقدي عمومًا- أن يقوموا بالتغيير من أعلى الهرم؛ ولذلك نرى أن كثيرًا من مقترحاتهم وتوصياتهم فيما يتعلق بالخطاب تتجه بدرجة كبيرة إلى المؤسسات والخطابات الرسمية كالمناهج التعليمية مثلًا. ولعل هذا التوجه نحو التركيز على السلطة المادية بوصفها هرمية وذات اتجاه واحد، يرجع بشكل كبير إلى التصور الماركسي التقليدي الصلب بعيدًا عن تأثيرات تيارات ما بعد الحداثة والبنيوية، وهو ما أعتقد بتناقضه مع الطموح المقاوم لتحليل الخطاب النقدي؛ إذ لو كانت السلطة تتسم بالهرمية وفاعلية المجموعات المهيمنة وخضوع المجموعات المهيمَن عليها فكيف يغدو بإمكان المجموعات الخاضعة المقاومة وتغيير ممارسات المجموعات المهيمنة.
العنصرية وإنكار العنصرية
يناقش فان دايك استراتيجيات إنكار العنصرية في الخطاب العنصري المهيمن والوظائف الاجتماعية والفردية والسياسية التي يؤديها هذا الإنكار، وذلك -كعادة فان دايك طوال الكتاب- في مختلف ميادين الخطاب وأنواعه، بوصفها -أي استراتيجيات إنكار العنصرية- جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للاستقطاب أو المربع الأيديولوجي؛ حيث يهدف الإنكار بشكل رئيسي إلى الدفاع عـ(نا). وتكمن أهمية إنكار العنصرية في تعارض العنصرية بشكل مباشر مع قيم الديموقراطية والتقدم الحضاري التي ينسبها العالم الغربي لنفسه باستمرار، ما ينفي كثيرًا من التاريخ والسمات الحضارية التي يتفاخرون فيها إذا ما تم الإقرار بالعنصرية كمشكلة حقيقية، كما أن العنصرية ليست اتهامًا يتعلق بفعل أو هفوة ما، بل هي اتهام متعلق بهوية الشخص وسماته الأكثر ثباتًا، وهو ما يزيد الأمر جديةً وخطورةً، كما وتعتبر العنصرية -خاصة في أوروبا- اتهامًا خطيرًا لارتباطه في أذهان الناس بالعنصرية النازية والفاشية المؤسسية الأيديولوجية الواضحة؛ لذلك كثيرًا ما يتم التخفيف من الممارسات العنصرية بوصفها “تحاملًا” و”معاداة الأجانب” و”التمييز” وغير ذلك، وتعتبر استراتيجية التخفيف أو التلطيف من أبرز استراتيجيات الإنكار المنتشرة في أوروبا، ومن الاستراتيجيات المتبعة لإنكار العنصرية هي إنكار نية العنصرية، وتحويل الاتهام بشكل عام على الآخرين كالجيران أو أعضاء مجموعتـ(نا) الآخرين، وإلقاء اللوم على الضحية (وهي حالة من حالات التخفيف والتلطيف؛ إذ لا يؤدي إلقاء اللوم على الضحية إلى نفي التهمة تمامًا عن الجاني)، وقلب الاتهام (وفي هذه الحالة يصبح الآخر هو المتهم، بعكس الاستراتيجية السابقة)، والتنصل والتنويه (تصوير النفس إيجابيًا يتبعها “لكن” ثم تصوير الآخر سلبًا) وغير ذلك.
وتتعدد أهداف إنكار العنصرية على مستويين، مستوى فردي جزئي، يتمثل في إبعاد التهمة عن الفرد نفسه، ومستوى اجتماعي كلي يشمل المؤسسات والأفراد؛ فحتى أنماط الإنكار الفردي تعتمد كثيرًا على تصوير الفرد ومجموعته ضمن مجموع المواطنين الصالحين. وبشكل عام، فإن الإنكار المؤسسي يهدف إلى تصوير العنصرية على أنها مشكلة عرضية وفردية أو أنها مشكلة خاصة ببعض المتطرفين من اليمين فقط -وهي استراتيجية متبعة بشكل كبير من الصحف الليبرالية في تغطيتها للعنصرية- وفي حالة قلب الاتهام يكون اليسار أو المهاجرون هم العنصريون -وهي استراتيجية متبعة بشكل كبير من صحف اليمين المتطرف والتابلويد- وذلك لإبعاد مؤسساتهم عن دائرة الاتهام.
يجعل اعتبار العنصرية مشكلة عرضية وليست مؤسسية منها مشكلة مرنة، أي أن انتشارها من عدمه يصبح معتمدًا على من يملك تأثيرًا أكبر على الجمهور (وهو في يد المجموعات المهيمنة بطبيعة الحال، حسب تصور فان دايك)، وهو ما يؤدي إلى سهولة تغيير التوجه المجتمعي متى ما رأت المجموعات المهيمنة ذلك، كالمزاج المحافظ المعادي للمسلمين الذي طغى على الولايات المتحدة بعد هجمات 11/9، وبالتالي تصبح محاربتها أكثر صعوبة على المجموعات المهيمَن عليها، وهذه هي الوظيفة السياسية لإنكار العنصرية. ويدرس فان دايك الصحافة الليبرالية في الفصل الخامس بشكل أكبر ويبين كيفية إسهام خطابها في تعزيز العنصرية، بالإضافة إلى صحف اليمين بطبيعة الحال.
الإدراك والنماذج العقلية
ينظر فان دايك إلى الخطاب بدايةً بوصفه تعبيرًا عن 3 مستويات من الإدراك: الإدراك الفردي/الشخصي، والإدراك المجموعاتي/المجتمعي، والإدراك الجمعي/الكلّي؛ فالخطاب أو النص الواحد قد يعبر عن هذه الأشكال الثلاثة في آن واحد. ولتحليل الإدراك بشكل أكثر دقةً؛ يستدخل فان دايك مفهوم النماذج العقلية، وهي الصورة/الصور التي يكوّنها العقل حول الأحداث والسياقات (السياسية) وتكمن وظيفتها الأساسية في الربط بين المعلومات والأفكار والتجارب الشخصية من جهة، وتلك الاجتماعية من جهة أخرى، وهي التي يقوم المتحدث بالحديث بناءً عليها -أي ينطلق منها في الحديث- حول الحدث المعين، ويقوم المستمع بفهم خطاب المتحدث بناءً عليها أيضا، وبالتالي، فهي تقوم بربط البنى والأحداث السياسية الكبرى بالبنى السياسية الصغرى كالأفعال والخطابات السياسية. ويبني فان دايك إطاره الإدراكي على الدراسات السابقة في حقل علم النفس الإدراكي والمفاهيم المتعلقة بالحقل كالذاكرة طويلة/قصيرة الأمد (حيث تتم معالجة المعلومات الداخلة في الذاكرة قصيرة الأمد من خلال وفي الذاكرة طويلة الأمد) والذاكرة العرضية والدلالية ووظائفهم المختلفة؛ حيث تقوم النماذج العقلية بوظيفة المنظم لآلية تصنيف وتوزيع المعلومات في الذاكرة طويلة الأمد. وبالتالي، لا يقوم الخطاب بالتعبير عن النماذج العقلية للمتحدث فحسب، بل يقوم -أيضا- بالتأثير على النماذج العقلية حول الحدث والسياق عند الجمهور واستثارتها، بحيث أن خطاب المتحدث يمر بالأنموذج العقلي لدى المستمع ويحدد الأنموذج بدوره ما إذا كان سيقبل الخطاب المطروح حول الوضع الراهن أو سيرفضه ويقوم ببناء نموذج آخر للحدث، ما يعني أن النماذج العقلية للسياق والحدث ليست ثابتة؛ بل تتغير عبر التفاعل الاجتماعي والخطابي. ويحدد فان دايك وظيفة نماذج الحدث بوصفها المسؤولة عن المضمون، أي عمّا يقال -وإلى حد ما الكيفية التي قيل بها- بينما تقوم نماذج السياق بشكل أكبر بالتحكم في كيفية صوغ (مثلًا الأفعال المستخدمة) هذا المضمون؛ فكما رأينا سابقا، تختلف صياغات الخطاب من الخطب البرلمانية إلى الخطاب الإعلامي والمحادثة العامة تبعًا لنماذج السياق، بينما تتشابه الاستراتيجيات المتبعة في الخطاب ومضمونه إلى حد كبير. غير أنه من المهم ملاحظة أن الخطاب الواحد لا يعبر عن الأنموذج الشخصي كاملًا، بل يعبر عن جزء يسير منه وهو الجزء المرتبط بالسياق والحدث الراهن فحسب. ويتبين من مفهوم النماذج العقلية اعتمادها الكبير على المعلومات والتجارب والاتجاهات الشخصية، وهو ما يجعل كل نص أو حديث متفرد بشكل أو بآخر، وليس مجرد تعبير آخر عن توجه اجتماعي معين. وهكذا، يتجلى لدينا مثلث الخطاب والإدراك والمجتمع بوصفهم محور مقاربة فان دايك ويتبين لنا علاقة كل منهم بالآخر -وخاصة مركزية الجانب الإدراكي في هذه المقاربة.
ويزودنا فان دايك بكيفية تأثير الخطاب على النماذج العقلية للجمهور عبر تحليل التلاعب، وهو الذي يحلله عبر آلية التثليث؛ إذ يرى -أولا- أن التلاعب ينطوي على سوء توظيف للسلطة؛ إذ تقوم به المجموعات المهيمنة لإقناع الآخرين بأمر هو في صالح الأولى فقط، وهو يحدث اجتماعيًا عبر ما ذكره حول النفاذ/المدخل والسلطة والموارد الرمزية والمادية المختلفة، بالإضافة إلى افتقاد المجموعات الخاضعة للمعرفة البديلة حول الموضوع المتحدَّث عنه. ويحدث التلاعب إدراكيًا عبر التأثير في التمثيلات والمعلومات الاجتماعية، وهي -كما ذكرنا- المكوّن الثاني للنماذج العقلية، وهي تعالَج في الذاكرة العرضية في الذاكرة طويلة الأمد وتصبح مستقرة وتستدعى لاحقًا من قبل النماذج العقلية للحدث عند وقوع أحداث مشابهة. وتقوم المجموعات المهيمنة بالتلاعب عبر عدد من الاستراتيجيات اللغوية والإدراكية المختلفة والتي قد تتشابه مع الإقناع المشروع كالتعميم والإقناع بوجود مصلحة للمجموعات المهيمن عليها بدلا من مصلحة المجموعات المهيمنة والمعارف والمعلومات والاستقطاب وجميع الاستراتيجيات المتفرّعة عنها وغير ذلك.
خاتمة: تقييم وعرض
قدم فان دايك في هذا الكتاب إسهامًا مهمًا في دراسات الخطاب النقدية تمثل -بشكل أساسي- في تغطية البعد الإدراكي كوسيط بين اللغة والمجتمع، وهو البعد الذي كثيرًا ما تم تجاهله في الدراسات السابقة في تحليل الخطاب النقدي، ويعطيه فان دايك دورًا مركزيًا انطلاقًا من اعتباره أن اللغة والبنى اللغوية بحد ذاتها هي ثابتة لا تتغير بغض النظر عن شرعية الخطاب من عدمه، أي حتى الخطاب الشرعي يستخدم البنى اللغوية نفسها التي يستخدمها الخطاب غير الشرعي، وهذا يعني أن الفرق الأساسي يكمن في السياق ونماذج السياق -أي الإدراك- ودونهما لا تكتسب اللغة أي معنًى حقيقي مستقل.
ولكن هذا التركيز على البنى الكلية والجزئية للإدراك قد أدى إلى إهمال حقيقي على مستوى المجتمع والنظرية الاجتماعية؛ إذ يقوم إطاره النظري -فيما يخص المستوى الاجتماعي- على عدد من المفاهيم والنتائج السابقة العامة في حقل النظرية الاجتماعية ولا يقدم شرحًا تطبيقيًا لكيفية ارتباط الخطاب بالمجتمع على المستوى الكلّي، باستثناء بعض اللمحات حول أنماط المدخل/النفاذ، وهو التصور المبني على التقسيم الماركسي التقليدي التراتبي للمجتمع، والذي يقتضي وجود مجموعات مهيمنة وأخرى خاضعة، وهو ما يتعارض بدوره مع مناقشة فان دايك النظرية للسلطة بوصفها تتيح مجالًا للمقاومة والفاعلية، ولعل هذا التناقض عائد إلى أن فان دايك لا يظهر اتساقًا بين النظرية والممارسة على المستوى الاجتماعي الكلّي، وهو عائد جزئيًا إلى إفادته من هذه النتائج السابقة في حقل النظرية الاجتماعية، والتي قد تجمع عددًا من التقاليد الفكرية التي قد لا تكون متوافقة دائمًا، كالماركسية الجديدة وما بعد البنيوية وحتى التعددية لروبرت دال في العلوم السياسية، وذلك دون مناقشة تفصيلية من قبل فان دايك نفسه لهذه النتائج والمفاهيم، ودون ربط عملي واضح لذلك بالخطاب والإدراك، باستثناء المقولة العامة القائلة بأن البنى الخطابية والإدراكية قيد البحث تساهم في استمرار الهيمنة وسوء استغلال السلطة على المستوى الاجتماعي الكلي، وهذا النقد قد نجده عند عدد من محللي الخطاب النقدي؛ وقد يعود هذا إلى رؤية مشتركة عبرت عنها ووداك -وحتى فان دايك بصورة غير مباشرة- مفادها أن النظرية الاجتماعية هي أداة كالأدوات اللغوية قد يفيد منها محلل الخطاب النقدي ويعدّل عليها في تحليله، وهو ما يؤدي إلى وجود نوع من عدم الاتساق إذا ما تم التعامل مع النظريات الاجتماعية بوصفها أدوات7. كما أن تصوره -على المستوى الاجتماعي الجزئي- حول أنماط المدخل/النفاذ لا يبدي اليوم استمرارية تمكننا من الاعتماد على هذا التصور؛ ففي مجتمع متعدد كالولايات المتحدة قد يملك أعضاء الأقليات نفاذًا حقيقيًا إلى الخطاب، ولكنهم استبطنوا أيديولوجيا النخب حتى أصبحوا مساهمين في إعادة إنتاج هذه الأيديولوجيا نفسها، وهو الأمر الذي لا يدرسه فان دايك، ولعل مفهوم فوكو حول السلطة وطبيعتها الاستيعابية قادرٌ على إسعاف فان دايك في هذا الجانب. 8
ولعل المفهوم المركزي للنفاذ/المدخل يحتاج اليوم إلى مراجعة لمعرفة أشكاله الجديدة المختلفة؛ ففي العصر الحالي ومع الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبح دور الإعلام التقليدي في تشكيل الخطاب العام أقل تأثيرًا، وهو ما قد نجادل بأنه قد عزز من الفاعلية والقدرة على المقاومة لدى المجموعات الخاضعة، وأظهر إمكانيات نفاذ مختلفة إلى الخطاب العام ينبغي دراستها لمعرفة مدى كيف يتم إعادة إنتاج السلطة عبر الخطاب بالشكل الحالي، بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة لعدد من الدول والحكومات في هذه الوسائل المستجدة للرقابة على المواطنين وتقييد المحتوى “غير المناسب” ونشر المحتوى الوهمي لصناعة الرأي العام وغير ذلك، أي لتملك نفاذًا أكبر إلى الخطاب، ولكن آلياته اليوم تختلف تمامًا عن آلياته في عصر الإعلام المتلفز والورقي.
1 Roger Fowler. “On Critical Linguistics.” In Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis, edited by Carmen Rosa Caldas-Coulthard and Malcolm Coulthard, 3–14. London and New York: Routledge, 1996.
2 Chouliaraki, Lilie, and Norman Fairclough. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.
3 لمناقشة مفصّلة حول موضعة تحليل الخطاب النقدي ضمن التقاليد والمقاربات الأخرى في تحليل الخطاب، راجع: ماريان يورغنسن، ولويز فيليبس. تحليل الخطاب: النظرية والمنهج. ترجمة شوقي بوعناني. المنامة: هيئة البحرين للثقافة والآثار، مشروع نقل المعارف، 2019.
4 Fairclough, Norman. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992.
5 Wodak, Ruth. Methods of Critical Discourse Studies. 3rd ed. London: Sage, 2015.
6 For more, review: Jäger, Siegfried, and Florentine Maier. “Theoretical and Methodological Aspects of Foucauldian Critical Discourse Analysis and Dispositive Analysis.” In Methods of Critical Discourse Studies, edited by Ruth Wodak and Michael Meyer, 34–61. London: Sage, 2009.
Caborn, Joannah. “On the Methodology of Dispositive Analysis.” Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines 1, no. 1 (2007): 112–123.
7 Breeze, Ruth. “Critical Discourse Analysis and Its Critics.” Pragmatics 21, no. 4 (2011): 493–525. https://doi.org/10.1075/prag.21.4.01bre.
8 للمزيد، راجع: فوكو، ميشيل، تاريخ الجنسانية:إرادة المعرفة. ترجمة سلمان حرفوش. القاهرة: دار التنوير للطباعة والنشر، 2017.

